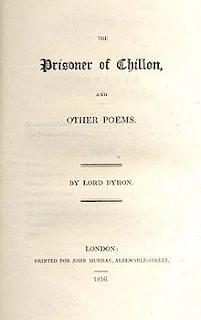كتبت د. إيمان الطحاوي
By Dr. Eman Tahawy, Egypt
Arabic post followed by the English translation
ألا يكفينا من الزمان يوم واحد لنحكي قصتنا؟ بلى،
فليكن يوم كسوف الشمس في الحادي عشر من أغسطس عام 1999. لم تكن هناك حرب، لم تكن
هناك مجازر، لم يكن هناك سوى بشر يريدون أن يسابقوا الزمن ليشاهدوا هذا الحدث
الرائع، عبر ما توفر لهم من إمكانيات. هذا يحضر ورقة آشعة، و هذا يشتري نظارة
مخصصة، و هؤلاء سيذهبون إلى تلال مرتفعة لمشاهدة الحدث النادر الذي قد لا يتكرر في
حياتهم.
كل بلدان أوروبا على هذا النحو. لكن هناك مشهد آخر مغاير
تماما، حدث في بلدة صغيرة (قرية كروشا إي مادهي ) في كوسوفو، صربيا، البلقان. سمها ما شئت. هو اليوم ذاته؛ هنا و هناك.
 |
| خريطة كوسوفو- ويكيبديا |
((ترك الصراع في كوسوفو في عام 1999 أكثر من 200 امرأة أرملة في قرية كروشا إي مادهي الزراعية، بينما فقد أكثر من 500 طفل هناك أحد والديه على الأقل)) - موقع الأمم المتحدة.
Krushë e madhe
كانت هناك أسر ما تزال تبحث عن جثث أو بقايا و رفات أحبائهم
الذين عذبهم و قتلهم جنود الصرب و طمسوا هوياتهم و أخفوهم في الأرض و النهر و
البحيرات و الغابات. تحت الطين و روث و جثث الحيوانات النافقة و بقايا الحجارة
المتكسرة من البيوت المتهدمة! ذهب فريق من الطب الشرعي لأداء المهمة و نسوا أنه
يوم الكسوف الكبير!
سنحكيه معا:
((قال: يا إلهي، إنه كسوف الشمس الجزئي. كنت قد نسيت ذلك ))
ثم تكدّس كل الفريق في قافلتنا الصغيرة، ثم نقلنا إلى قرية كروشا مادهي الخاوية. دُمرت معظم المباني السوداء تقريبًا. كالعادة، فُجّرت الأسطح، واختُرِقت الجدران بمئات من رصاص الكلاشينكوف.
وصلنا إلى ورشة عمل صدئة ومسطحة بسقف من الحديد المموج في حديقة ملأى بالأعشاب البرية، و فيها سيارتان صدئتان داخل
المنحدر.
أمسك ثلاثة رجال شرطة آخرين بالمجارف والفأس، وشقّوا طريقهم إلى منطقة في
الحديقة، وطوّقوها بشريط مسرح الجريمة الملون باللونين الأصفر والأسود، ثم بدأوا
في الحفر بالمعاول، في حين كان بقيتنا يشاهد تحت مظلة الترحيب. عادوا يسبحون في عرقهم بعد نحو خمس
عشرة دقيقة.
قال أحدهم: “الحرارة
اللعينة تغلي هناك”.
فجأة، حل الظلام عندما اختفت الشمس من السماء الصافية، وأصبح الجو باردا
بوجه غريب ومظلما تمامًا.
“هل هذا فأل حسن؟” سألت أندرو.
قال: “يا
إلهي، إنه كسوف الشمس الجزئي. كنت قد
نسيت ذلك “.
قال أحد رجال الشرطة مازحا: “كما قلت، يا روب، فأل”.
انضممت إلى أندرو ولانا واثنين من رجال الشرطة، وواصلنا الكشط والحفر حيث ترك الآخرون خندقًا كبيرًا ملحوظًا.
سرعان ما اختفى الهواء البارد مؤقتًا، وبدأت درجة الحرارة في الارتفاع الكبير. بعد نحو خمس دقائق فقط من الحفر و نحن نسبح في عرقنا، صادفنا ما بدا أنه سجادة دكناء مطوية وملطخة بالدماء، فتحناها لتتشكف لنا عن جثث ما يشبه طفلين.ولوح أحد رجال الشرطة للآخرين في المأوى المنحدر، مشيرًا إليهم بالنزول،
عندما وصل فجأة اثنان من الرجال الكوسوفيين، وأخرجوا آلات التصوير، وبدأوا في
التقاط صور للأطفال الذكور الملطخين بالدماء والمشوهين لدرجة رهيبة الذين تبلغ
أعمارهم نحو اثني عشر عامًا أو نحو ذلك.
“ما
هذا الذي يفعلونه؟ هذا هو مسرح الجريمة الخاص
بي، إنهم يتجولون في كل مكان! “ صرخ جون في المترجمة الشابة إيرما.
تحدثت إيرما إلى الرجال، الذين تجاهلوا صخب جون. وتمتموا بردود لها و هم
يواصلون التقاط الصور.
بدت إيرما مرتجفة، ثم ترجمت سريعًا ما كانوا يقولونه:
“لكيلا ينسوا مطلقا ما فعله الصرب بهم. و ليتمكنوا من إظهار الصور لأولادهم وأحفادهم “.
“ حسنا...! دعونا
نخرج الجثث”، قال جون.
كانت جثث ما يشبه امرأة ورجلين ووجوههم مغطاة جزئيًا تحت الأطفال. طلبنا من إيرما إقناع الكوسوفيين أن
الأمر انتهى ويجب عليهم المغادرة، وهو ما فعلوه، ويبدو أنهم مترددون، لكن راضون
عما حققوه. نظر إلينا رجل، خمنت أنه
في الخمسينيات من عمره، وربت صدره بيد واحدة كما لو كان يقول شكرًا لك.
عندما ذهبوا، طلب أندرو من أحد رجال الشرطة التقاط صور للضحايا في الموقع. لقد وجدت ذلك مثيرًا للسخرية، لكن
صورنا التُقطت لأسباب مختلفة عن أسباب الكوسوفيين. عندما كشف شرطي خرق الملابس الممزقة التي تغطي وجوه الضحايا البالغين،
شهقنا جميعًا بسبب مستوى التشويه الذي نالهم.
كانت أنوفهم وآذانهم مفقودة، وكانت هناك علامات على وجود ضربة عنيفة حول
محاجر أعينهم الفارغة تقريبًا. تخلف في المحاجر دماء سوداء متجمدة فقط حيث كانت أعينهم ذا
يوم. كان كل وجه مغطىً تقريبًا بقناع
من الدم الجاف، أما ما نراه من أجسادهم، فكان متورما و مصابًا بكدمات شديدة. كان واضحًا أنهم تعرضوا للضرب وإطلاق النار عدة
مرات.
شاهدت لك فيلم الكسوف- الجزء الثاني
شيء بقلبي: فيلم الكسوف- الجزء الثالث
Wouldn't one day be enough to tell our story? OK...That would be the day of the eclipse, August 11, 1999. No war, no massacres. Just ordinary people attempting to witness this amazing incident as best they could. This man would get an x-ray sheet. Others would buy special glasses. Some would climb high hills to observe a rare event that may never happen again. In any European country, you can see the same scene. However, in a small village in Kosovo (Krusha i Madhi), a different scene unfolded.
By Robert Mcneil MBE, UK
John gathered the team together in the mortuary for the morning meeting. I had noticed him earlier in deep conversation with some civilians at the gates of the mortuary. “As you know, we’ve now dealt with almost all of the bodies stored in the reefer. Today we’re going to exhume a grave in a small village about five miles up the road. Apparently, there is a family of between five and seven people in the grave, who were allegedly executed by Serb paramilitaries a month or so ago. I’d like to introduce you to Irma, our interpreter for today.” A beautiful girl, her blonde hair in a tight bun, smiled slightly and nodded to us. She looked as if she were only in her late teens. John motioned to Kriss, Andrew, the anthro, and me to step outside. The group of civilians consisted of three local Kosovar men and a woman waiting on a tractor trailer to take us to the locus. Irma translated the details of the story they told her. She looked shocked as she listened intently to the horror story as told to her by the Kosovars. The family, she said, after being tortured, had been taken out of their home by Serbs, killed and buried. These people knew exactly where they had been buried. They wanted us to exhume the bodies, because they thought we would have the authority to then find and punish the perpetrators. John asked Irma to inform them that we couldn’t do that, but he would inform the people who might. The team then all piled into our small convoy of two Land Rovers plus an open truck and were led to the empty village of Krusha Madhe. Most of the blackened buildings had been all but destroyed. As usual, the roofs were blown off and the walls were pockmarked by hundreds of Kalashnikov bullets. We arrived at a rusty, flat, corrugated-iron-roofed workshop in a garden overgrown with weeds, with a couple of rusting cars inside the lean-to.
“OK, folks, suit up. It’s going to be another scorching day, especially in these f...ing paper suits, so make sure to drink plenty of water,” John said. One of the cops brought in two packs containing large bottles of cold drinking water and placed them on the bonnet of one of the old cars. Three other cops grabbed shovels and a pickaxe and made their way over to an area in the garden, cordoned it off with yellow and black police scene tape and then started digging with the shovels, while the rest of us watched from the welcome shade and shelter of the lean-to. After about fifteen minutes they returned, bathed in sweat. “F...ing boiling out there,” one of them said. “Next shift,” John said. “No more than fifteen minutes.” Suddenly, the sky darkened as the sun disappeared from the cloudless sky and it became strangely cold and quite dark. “Is this an omen?” I said to Andrew. “My goodness,” he said, “it’s the partial eclipse of the sun. I’d forgotten about it.” “Just as you said, Rob, an omen,” one of the cops joked.
 |
| Kosovo, 1999 |
I joined Andrew, Lana and two of the cops and we continued scraping and digging where the others had left a significantly large trench. The temporarily cool air soon disappeared and the temperature began to rise dramatically. After about only five minutes of profuse sweating and shovelling, we came across what appeared to be a dark, soiled, blood-stained folded carpet, which we opened to reveal the bodies of what looked like two children. One of the cops waved to the others in the lean-to, motioning them to come over, when suddenly two of the Kosovar men arrived, produced cameras and started taking photographs of the bloodied and terribly mutilated male children aged around twelve or so. “What the f... are they doing? This is my f...ing crime scene they’re tramping all over!” John shouted at Irma, momentarily forgetting that he wasn’t at home working in a secure crime scene. Irma spoke to the men, who, ignoring John’s rant, muttered answers to her as they continued to snap away with their cameras.
Irma, clearly shaken, translated at speed as the men spoke: “So they will never forget what the Serbs have done to them. So they can show the photos to their children and to their grandchildren.” “F... it!” John said. “Let’s get them up.” The bodies of what looked like a woman and two men with their faces partially covered lay underneath the children. We asked Irma to impress upon the Kosovars that it was all over and they should leave, which they did, seeming reluctant but satisfied with what they had achieved. One man, who I guessed was in his fifties, looked at us and patted his chest with one hand as if to say thank you. When they had gone, Andrew asked one of the cops to take photos of the victims in situ. I found this ironic, but our photos were being taken for different reasons than those of the Kosovars. When a cop uncovered the torn rags of clothing covering the faces of the adult victims, we all gasped at the level of mutilation carried out on them. Their noses and ears were missing, and there were signs of serious trauma around their almost empty eye sockets. All that was left in the eye sockets was blackened, congealed blood where their eyes had once been. Each face was almost covered in a mask of dried blood, and what we could see of their bodies was badly bruised and swollen. It was also clear they had been beaten and shot multiple times.
When, at last, the cops had finished their CSI work at this scene of carnage, we loaded the five bodies carefully onto the truck driven by Timi. I joined Irma in the back of the Land Rover driven by Jack, the police sergeant from the Met who’d picked me up when I first arrived at Skopje Airport. We all stank of death, dirt and stale sweat. Irma looked at me for a moment, then she said quietly, “You have a terrible job.” Silence for a moment or two. “So do you,” I said, forcing a half-smile.
Movie (The Eclipse, 2022)
Part 1 (Another True story on 11-8-1999)
https://shayunbiqalbi.blogspot.com/2023/03/1.html